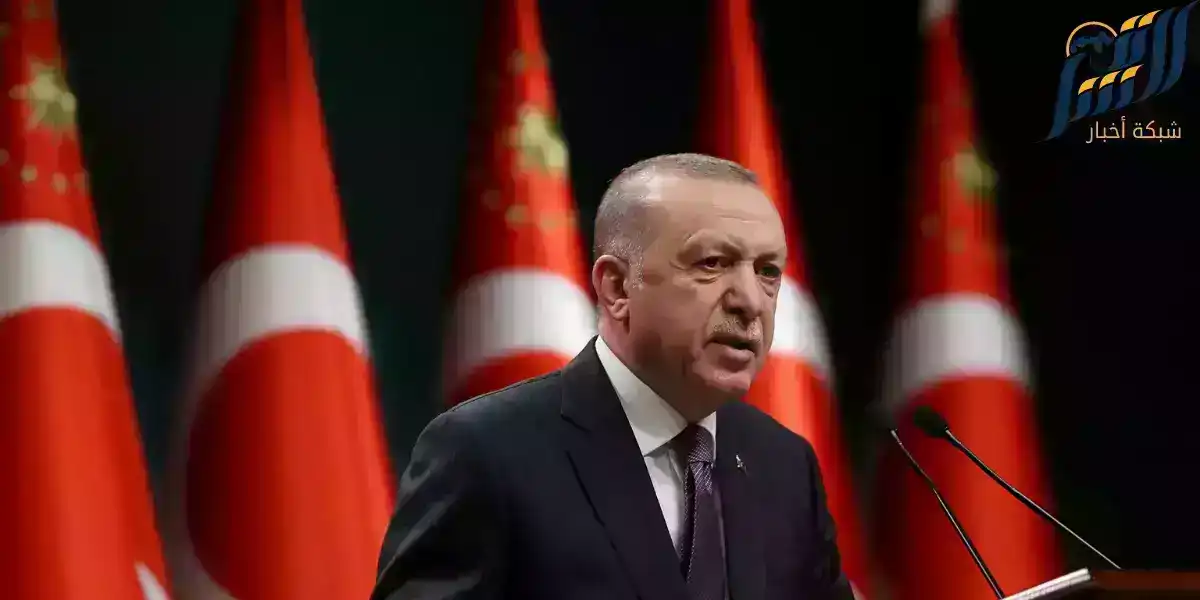تاريخ حافل تجاوز 100 عام، جعل السينما المصرية تصل إلى مرتبة الزعامة عربيًا بلا ملهم، وقبسًا يهتدي إليه الحائر من تاريخ مشوش وحاضر بائس، وما بينهم حلّق الفن السابع مرشدًا وموجهًا.
ورغم ما شهدته صناعة السينما المصرية من تطور، إلا أن ضغوطات اقتصادية واجتماعية بل حتى سياسية، وقفت حجر عثرة أمام نجاح غير مسبوق في المنطقة العربية دفع السينما المصرية للصدارة خلال حقب زمنية طويلة، إلا أن الأزمات المتتالية جعلت تلك الصناعة عاجزة عن تلبية الآمال التي كانت معقودة عليها من عشاق الفن السابع.
تطور صناعة السينما المصرية من التأميم للانفتاح
تختلف آراء الباحثين حول بداية ظهور الفن السينمائي في مصر، حيث يرجع البعض البداية الأولى لظهور الشرائط السينمائية عام 1907، عبر تجارب لأعمال تسجيلية قصيرة أشرف عليها محمد بيومي ومحمد كريم، وهما أهم رواد السينما والرعيل الأول لتلك الصناعة في مصر.
وبعد عودة كريم وبيومي من أوروبا حيث تلقيا دراسة مستفيضة عن الفنون السينمائية، تأثر الأخير بثورة 1919 مصممًا على المشاركة في صناعة سينما وطنية تعبر عن الواقع المصري بعد الثورة ضد الاستعمار الإنجليزي، فأخرج فيلمي "عودة سعد زغلول من المنفى"، و"برسوم يبحث عن وظيفة" عام 1923 من بطولة الفنان السوري بشارة واكيم.
وسرعان ما ابتعد بيومي عن السينما حيث انغمس في العمل الحزبي السياسي، فيما كان لمحمد كريم النصيب الأكبر في الشكل الذي أصبحت عليه السينما المصرية فيما بعد.
وظهر أول فيلمين روائيين طويلين في مصر عام 1927، وكان الصدى الأكبر من نصيب فيلم "ليلى" للنجمة المسرحية عزيزة أمير، ودُعى إلى افتتاح العرض الخاص للفيلم شعراء ورجال أعمال وأبرز الاقتصاديين والسياسيين آنذلك، منهم طلعت حرب وأحمد شوقي، الذين رحبوا بالبداية الجديدة للسينما المصرية.
وأنتج محمد كريم فيلم "زينب" ليكون أول فيلم صامت مصري يستخدم تقنيات حديثة غير معهودة وقتها، والعمل مأخوذ عن رواية للأديب والشاعر محمد حسين هيكل، وحقق الفيلم نجاحًا باهرًا، مما أكد أن هناك مستقبل باهر في انتظار الصناعة السينمائية الوليدة.
وأنتج رائد المسرح يوسف وهبي بالتعاون مع محمد كريم، أول فيلم عربي ناطق يحمل اسم "أولاد الذوات"، ثم اتجه كريم إلى الأفلام الغنائية مستهلًا تلك الأعمال التي ميزت حقبة الثلاثينات والأربعينات من القرن الماضي، بفيلم "الوردة البيضاء" من بطولة المغني والموسيقار محمد عبد الوهاب.
ويعد إنشاء أستوديو مصر عام 1935، لمؤسسها الاقتصادي طلعت حرب، من أهم مراحل تطور السينما المصرية، فقد شكلت نقلة ثبتت أقدام الفن السابع في مصر، حيث اتجهت صناعة الفيلم لتواكب هوليوود، عبر الاعتماد على شركة تمتلك معامل تحميض وطباعة ودور عرض، وتمت الاستعانة بخبرات أجنبية، استطاعت تخريج المئات من الكوادر الفنية المصرية.
وأشرف قسم التوزيع في استوديو مصر على تصدير الأعمال التي أنتجها ليس فقط عربيًا، بل تجاوز ذلك إلى الصعيد الدولي، أمثال فنزويلا وهونج كونج ودول أوروبية، لتصبح بذلك صناعة السينما ثاني أهم الصناعات في مصر بعد تصدير القطن.
وعلى غير المتوقع، كانت الحرب العالمية الثانية حتى عام 1945، العصر الذهبي للسينما المصرية، حين بحث المستثمرون عن عائد سريع لأموالهم من خلال التوسع في الإنتاج السينمائي، بينما الشعوب وجدت في السينما ملاذًا لهم من واقع دموي ومشاهد العنف التي لا تتوقف.
ولعبت الصناعة السينمائية دورًا لا يقل أهمية عن الخُطب السياسية ومقالات كبار الكتاب إبان ثورة 23 يوليو عام 1952 التي أطاحت بالحكم الملكي، مدشنةً مرحلة أخرى شهدت إنشاء المعهد العالي للسينما عام 1959، لتجديد دماء الصناعة الحديثة، وتم إنتاج الفيلم الأشهر "رُدّ قلبي" لأديب الثورة يوسف السباعي، والذي جسّد فيه حال الأسرة المصرية إبان العهد الملكي والفروق الاجتماعية بين الباشوات والغلابة.
وفي عهد الرئيس المصري الراحل جمال عبد الناصر، تم تأميم شركة "مصر للسينما" وغرفة صناعة السينما، لتدخل الدولة لأول مرة بقوة في الإحاطة بصناعة الأفلام.
وفي زمن الرئيس الأسبق محمد أنور السادات، استخدمت السينما لكشف سيئات ثورة يوليو، فتم إنتاج أفلام عبرت عن الدولة البوليسية التي أرهبت المصريين لعقدين من الزمان، أمثال "الكرنك" للكاتب نجيب محفوظ و"البريء" للكاتب وحيد حامد وبطولة أحمد زكي.
الإنتاج السينمائي.. أزمات متكررة ومطالب لا تجد آذانًا
تمتلك السينما المصرية إمكانيات هائلة تؤهلها لتقديم صناعة متميزة، إلا أن الصناعة تمر بالعديد من الأزمات نظرًا لمتغيرات كثيرة ألمت بها في الفترة الأخيرة، في حين أن الحلول مطروحة على الطاولة لكن لا تجد مَن يوليها اهتمامًا.
كثير من المنتجين لا يعنيهم سوى الربح التجاري حتى على حساب جودة العمل، بينما تكاليف الإنتاج في ارتفاع مستمر نظرًا لفرض الدولة ضرائب بأسعار تصاعدية، في الوقت الذي يغالي فيه كبار النجوم من أجورهم، بينما شاشات العرض شبه محتكرة من عدد من رجال الأعمال.
وعلى الرغم من أن بيانات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء تشير إلى ارتفاع قيمة إيرادات السينما في 2015 إلى 266.5 مليون جنيه، إلا أن صناع السينما في تخبط مستمر نتيجة تركيزهم على الاستحواذ على نجوم الشباك بدلًا من وجود خطة للإنتاج واضحة المعالم؛ والنتيجة تراجع الإنتاج السينمائي مقارنةً بالفترات السابقة.
وشهدت تلك الفترة تحولات اقتصادية وسياسية، أثرت على معدلات الإنتاج، خاصةً مع تنامي قرصنة الأفلام وبثها على المواقع الإلكترونية، فبعد أن كان ينتج سنويًا في 2006 ما يقارب 59 فيلمًا، تقلص العدد إلى 22 فيلم فقط بعدها بأربع سنوات نتيجة الخسائر التي يتكبدها المنتج السينمائي.
واتجه المنتجون إلى الدراما التلفزيونية لتكون متنفسًا أكثر أمانًا بديلًا عن السينما، وفي هذا الإطار علق المنتج محمد العدل رئيس شركة العدل جروب، قائلًا إن الإنتاج التلفزيوني الفترة الحالية أصبح أكثر تكلفةً من الإنتاج السينمائي، ويصل تكاليفه إلى 3 مليار جنيهًا سنويًا، وعلى الرغم من ذلك يطمئن المنتج قبل شروعه في الإنتاج إلى بيع المسلسل وتحديد حجم التكاليف الأرباح، بخلاف السينما التي لا يمكن توقع استعادة النفقات في شكل أرباح.
ويرى الناقد الفني محمود عبد الشكور، أن السينما المصرية لم تستطع التحول إلى صناعة راسخة، إثر غياب رؤية إنتاجية محددة، والاعتماد على النجاح الجماهيرى لنجم معين، وذلك بالرغم من أن السينما المصرية عرفت الملايين خلال الفترة الأخيرة سواء فى الأجور أو الإيرادات.
بعد القطيعة.. هل تنقذ الدولة صناعة السينما؟
استراح الجميع لإزاحة الدولة وانتهاء عصر التأميم لمبنى ماسبيرو، بعد إنتاج آخر الأعمال السينمائية عام 1971 بتمويل حكومي وحمل الفيلم اسم "المسافر" بطولة النجم العالمي عمر الشريف، لكن السينما لم تسترح، واكتشف السينمائيون أن الصناعة أحوج من غيرها إلى دولة تدعمها.
ورغم ابتعاد الدولة تمامًا عن الإنتاج السينمائي عقب خسائر تكبدتها مدينة الإنتاج الإعلامي المعروفة باسم "ماسبيرو"، ينادي نقاد وصناع السينما بعودة الدولة للتدخل لإنقاذ الصناعة الوطنية من التدهور.
بدوره، أعد المركز المصري للدراسات الاقتصادية، دراسة تحليلية حول توقعاته لصناعة السينما في ظل أزمة كورونا، لافتًا إلى أن تأثير الجائحة شديد على الصناعة الوطنية، خاصةً أن السينما صناعة تصديرية من الدرجة الأولى، وبالتالي فهي في حاجة لدعم حكومي يساهم في تعويض الخسائر وهبوط الإيرادات إثر تداعيات الإغلاق الذي تبنته الدولة إبان تفشي الجائحة.
وطالبت الدراسة، بمراجعة العبء الضريبي على تذاكر العرض، حتى يتسنى للمنتجين تعويض خسائرهم، مع تأجيل الالتزامات الضريبية على الشركات المنتجة، ومنحها قروضًا ميسرة على غرار عدد من القطاعات في الدولة، حتى تعود الصناعة لمعدلاتها المعتادة في الإشغالات.
وأفاد المركز المصري للدراسات الاقتصادية، بأن النصف الأول من عام 2020، خسرت صناعة السينما المصرية 270 مليون جنيه، وتعرض 300 ألف عامل تابع لشركات إنتاجية مصرية للتسريح من وظيفته، نتيجة إغلاق دور العرض السينمائي، مع تنامي حالات الإصابة بفيروس كورونا.
من جانبه، انتقد صبرى السماك نائب رئيس رابطة المنتجين الفنيين، تخاذل الدولة في دعمها صناعة السينما، لافتًا إلى أن تكاليف الإنتاج زادت 30% منذ تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي في 2016 مدفوعة بانخفاض قيمة الجنيه أمام الدولار، واعتماد الشركات على معدات التصوير المستوردة لضعف الإنتاج المحلي، بينما لم تحرك الدولة ساكنًا.
ويرى المنتجون أن استمرار رفع الدولة يدها عن صناعة السينما، ينذر بمستقبل سيء للصناعة، فالأفلام الرديئة ذات الميزانيات الضئيلة انتشرت، وقلت الأعمال المعروضة، وعزف المشاهد عن الذهاب لدور العرض مكتفيًا بالمواسم، في الوقت الذي ما يزال صناع السينما يعولون على الدولة التدخل من جديد منقذةً السينما من مزيد من التهاوي.